لا يخفى على أحد ذلك الخلل الكبير في المستوى العلمي لكثير من المسلمين، وأحيانًا يكون الخلل عند الملتزمين بتعاليم الدين، علمًا بأن مستوى هؤلاء الملتزمين في العلوم الشرعية غالبًا ما يكون على درجة طيبة جدًّا. مما يعكس اهتمامًا بالجانب الشرعي، وتغليبه -إلى حدٍ كبيرٍ- على الجانب الحياتي في قضايا العلوم والتعليم.
الانفصام بين علوم شرع وعلوم الحياة
وهذا الفصل في الاهتمام بين علوم الشرع وعلوم الحياة أمرٌ غريبٌ على الشريعة الإسلامية، ودخيل على أمتنا، وهو أمر جد خطير؛ لأنه كما لا يصلح بناء الأمة الإسلامية بغير العلوم الشرعية، فكذلك لا يصلح بناء الأمة الإسلامية بدون العلوم الحياتية، والفصل بينهما - لا شك - يؤخر المسيرة، بل يكاد يوقفها، وما عرِفَتِ الأمة الإسلامية السيادة والقوة والمجد والصدارة إلا وكانت علومها الحياتية قوية وسابقة، وما عرفت الأمة الإسلامية الضعف والتأخر والتخلف إلا وكانت علومها الحياتية ضعيفة ومهملة. والتاريخ خير شاهد على ذلك، وفي أكثر من موضع.
لماذا حدث هذا الفصام غير المفهوم؟!!
على ما يبدو فإن القضية في الأساس هي قضية فَهْم. وإن كان للأعداء تخطيطهم وتدبيرهم، إلا أن العيب ينبع أساسًا من داخلنا. فعلى مدار السنوات الماضية اختل فهم المسلمين -سواء بفعل فاعلٍ خارجي أو داخلي- لمعنى كلمـة "العلم النافع"، فصاروا يقصرونها على العلوم الشرعية فقط، مع أن الأدلة متواترة على عكس ذلك.
والأمر هذا كان مترتبًا على فهم أن ساحة التقرب إلى الله تعالى محصورة فقط في الشعائر التعبدية المحضة، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أما ساحة الدنيا وعمرانها وإصلاحها وتسخير إمكانياتها، فقد ابتعدت عن تلك التي أُريد بها وجه الله سبحانه.
ففي العقود الأخيرة التي مرت بأمتنا نظر كثير من المسلمين إلى العلوم الحياتية نظرة إهمال، بل نظرة ازدراء وتنقيص، وساعد على هذا الفهم الخاطئ بعض العلماء الذين قسَّموا العلوم إلى علوم دينية وعلوم دنيوية، فغدت علوم الطب والهندسة والكيمياء، وما على شاكلتها علومًا دنيوية، بينما علوم الشريعة من فقه وتفسير وعقيدة وغيرها هي العلوم الدينية أو الأخروية!!
وهكذا فإن المسلم الملتزم سرعان ما يشعر بحرجٍ شديد وهو يدرس هذا العلم الدنيوي؛ إذ أنه ينصرف بذلك -فيما يعتقد- عن علوم الآخرة، وهذا يعني عنده أنه سيترك شيئًا من أمور "الدين" إلى شيء من أمور الدنيا!!
لماذا علوم الحياة؟!
الدنيا بصفة عامة مذمومة في الكتاب والسنة، وما أكثر الآيات والأحاديث التي جاءت تحث المسلمين على الزهد فيها، وعدم الاكتراث بها ولا بحجمها. والأمر في ذلك أكثر من أن يُحصى، ويكفي للدلالة عليه أن نورد قوله تعالى: {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [يونس: 24].
ويقول سبحانه أيضًا منقصًا من شأنها وقدرها: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ} [التوبة: 38].
وروى المستورد الفهري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي اليمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ" [1].
كذلك روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ" [2].
ونتيجة لربط هذه العلوم الطبيعية والحياتية بالدنيا، نظر الملتزمون إليها على أنها مما يُبعد عن الدين الإسلامي، وأن الاشتغال بها أمرٌ مذموم، وأن الدارس للهندسة -مثلاً- والكيمياء وعلوم الذرة، هو رجلٌ نسي دينه واهتم بدنياه!!
والحق أن هذه كلها أباطيل ما أنزل الله بها من سلطان؛ فعلوم الطب والهندسة وغيرها هي طرقٌ واضحة من طرق الجنة إذا صلحت النوايا وأخلصت لله تعالى، وهي علوم "أخروية" إذا ابتغى بها العبد ثواب الآخرة، وهي علوم "دينية" إذا أردا بها المسلم نصرة دينه ورفعة أمته.
والواقع كذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا تُجَّارًا وزُرَّاعًا وصُنَّاعًا، وقبلهم أنبياء الله عليهم السلام، كلٌ كان له حرفة وصناعة بجانب مهمته الأساسية، فكان آدم حراثًا، وكان داود حدادًا، وكان نوح نجارًا، وكان إدريس خياطًا، وكان موسى راعيًا، وكان زكريا نجارًا. فلم يقعد بهم انشغالهم بالآخرة والعمل لها وتعليم علومها عن العمل للدنيا وتعميرها وتسخيرها وتعليم علومها..
بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نظر إلى رجلٍ ذي سيما (هيئة حسنة) قال: أله حرفة؟ فإن قيل لا سقط من عينه [3]!! ثم ماذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ" [4]؟! لماذا يغرسها وهي من نفع الدنيا، فضلاً عن أنه لن يستفيد منها دنيويًّا أصلاً؟!
والذي يُفهم من ذلك كله هو -كما يُعبر الدكتور عبد الباقي عبد الكبير [5]- أنه في سعْينا لقضاء حوائجنا والقيام بمسؤولية عمران الأرض ووظيفة الاستخلاف فيها بنية خالصة، سعْيٌ لإرضاء لله عز وجل. بل إن في سعْينا لعمران الأرض، وتعليم علومها، والوقوف على ثغراتها التنموية، وإخراج المجتمع من عوْز الحاجة، كلٌ في مجاله وحسب إمكانياته وقدراته الوظيفية. هو في الأساس سعيٌ لإعلاء كلمة الله تعالى ورفع راية الإسلام [6].
وعليه، وإذا كانت القضية في الأساس -كما رأينا- قضية فَهم وسوء فقه. فإننا نود القيام من ركائز ومنطلقات صلبة وقويمة، هي من أساس ديننا ومن صلب معتقداتنا.
وفي بداية هذا الطريق فلا أحبذ أبدًا إطلاق لفظ علوم "دنيوية" على هذه العلوم، وإنما يمكن أن نطلق عليها "علوم الحياة". فهي علوم أراد الله تعالى لنا أن نتعلمها لنصلح بها حياتنا على الأرض. والحياة بصفة عامة ليست مذمومة كالدنيا، بل هي نعمة من الله تعالى.
وانظر إلى قوله سبحانه وهو يربط بين مراعاة أحكام الشرع وبين الحياة الطيبة حين يقول: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} [النحل: 97]. وهكذا، فتكون علوم "الحياة" من هذا المنظور، والتي تعني شيئًا عظيمًا علويًّا، أرقى وأعظم من علوم "الدنيا"، والتي تعني الدونية والسفلية. ويوضح هذا المعنى وذاك المراد قوله تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: 122]. وعلى هذا النهج تسير كثير من الآيات والأحاديث.. مما يعطي ثراءً ملحوظًا لكلمة الحياة.
هل يعقل أن يُهمل المسلمون علوم الحياة؟!
ثم لنقف وقفة نحاور فيها ونناقش أولئك الذين صرفوا جل وقتهم واهتماماتهم لعلوم الشريعة، ولم يشاءوا أن يصرفوا قدرًا من جهدهم وفكرهم ومالهم ووقتهم لعلوم الحياة. ونجيب معهم على سؤال مهم مفاده: هل يعقل أن يُهمل المسلمون علوم الحياة؟؟ وفي معرض الجواب بالنفي الصريح على هذا السؤال، نقدم هذه الأدلة وتلك البراهين القطعية على نُبل هذه العلوم إذا ما وجهت لخير الأرض، ونفع البشرية، ورفعة هذا الدين، وعزة هذه الأمة.
هل نسي الإنسان أن الله تعالى قد جعله "خليفة" في الأرض؟!
وحين تكون الإجابة قطعًا بالنفي، فلنتفكر معًا: كيف يمكن أن يُستخلف الإنسان في الأرض وهو لا يعلم شيئًا عن علومها؟!
فالحقيقة التي لا مراء فيها أن الذي يُستخلف في الأرض يجب أن يعرف ربه، وأن يعرف كيف يعبده، ثم لابد له أن يعلم طبيعة المكان الذي استخلف فيه، وكيف يمكن استغلاله لعبادة الله رب العالمين، قال تعالى:{هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}[هود:61].
فمن شروط الاستخلاف، ومن واجباته الأساسية، أن يعرف الإنسان كيف "يَعْمُر" الأرض، وكيف يكشف كنوزها ويستفيد من ثرواتها. وكيف يُسخِّر كل ما يمكن أن تصلح به "الحياة" على وجه هذه الأرض. ولما خلق الله آدم عليه السلام، وعظمه ورفع قدره، وأسجد الملائكة له. لم يكن ذلك إلا بالعلم الذي أتاه إياه، قال تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البقرة: 31].
والسؤال إذن: ما هذا العلم الذي علمه الله آدم عليه السلام، وبه تفوق على الملائكة؟
لقد علَّمه الله تعالى فيما يروي ابن عباس رضي الله عنهما أسماء كل شيء: الجبل، والشجر، والبحر، والنخلة، وأسماء الناس والدواب [7]. أي أن الله تعالى علمه العلوم "الطبيعية" التي سيحتاج إليها للحياة فوق الأرض وعمارتها، أما الملائكة فهي لا تعلم هذه الأسماء وتلك العلوم؛ لأنها لن تستخلف على الأرض، ومن ثم فهي ليست في حاجة إليها.
والواضح أنه لو علَّم الله تعالى آدم عليه السلام العبادة بمفهومها المقتصر على الصلاة والصيام والذكر والدعاء، لتفوقت الملائكة على آدم عليه السلام في هذا المجال، وما كان هناك داعٍ أن يُستخلف الإنسان في الأرض، بل يعيش في السماء كما تعيش الملائكة، يفعل أفعالهم، ويكتفي بعلومهم: {يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} [الأنبياء: 20].
فلم يكن علْمُ آدم عليه السلام علمًا شرعيًّا فقط، وإنما كان علمًا حياتيًّا كذلك، وعليه فإن الإنسان إذا أهمل العلوم الطبيعية أو علوم "الحياة"، فإنه بذلك يُهمل أهم مقومات استخلافه على الأرض، وهذا لا يجوز في حق مسلم واع، يفهم دينه، ويدرك طبيعة استخلافه على الأرض.
هل اكتملت علوم الحياة؟
أكمل الله تعالى العلوم الشرعية قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]. وليس هناك وحيٌ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فستبقى العلوم الشرعية كأصول كما هي. نعم قد يجتهد علماء الشرع في بعض الأمور بحسب المتغيرات والمستجدات في البيئة والزمان والمكان، ولكن تبقى الأصول ثابتة موجودة في القرآن والسنة.
هذا بالنسبة للعلوم الشرعية. أما بالنسبة لعلوم الحياة، فإن الأمر يختلف؛ إذ أنها علوم لم تكتمل بعد، ولن تكتمل أبدًا، ففي كل يوم يمر علينا يُكشف لنا كشفٌ جديد في هذه العلوم، وعلم اليوم في الطب -مثلاً- يختلف عما سيكون عليه غدًا، وهما غير ما كانا عليه بالأمس وهكذا.
فعلوم الحياة في تطور وتغير مستمر، وما يُعَدُّ اليوم حقيقة علمية، قد يُكتَشف غدًا أنه وهم لا أصل له، أو أن هناك ما يتخطاه ويتعداه، وما أكثر المعتقدات العلمية التي ظلت موروثة لمئات السنين، ولم تتغير إلا منذ سنوات قلائل بعد اكتشاف خطئها.
يقول تعالى: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [فصلت: 53]. فالآية نزلت بصيغة المستقبل، وستظل تُقرأ إلى يوم القيامة بصيغة المستقبل، وسيظل المستقبل إلى يوم القيامة يحمل جديدًا في علوم الحياة، سواء كان في الكون (في الآفاق)، أو في الإنسان (وفي أنفسهم). والعمل الدءوب في هذا المجال مطلوب ومهم، وإلا سبق الركب، وتعذَّر اللحاق!
حاجة علوم الشرع لعلوم الحياة
هناك الكثير من القضايا الشرعية والفقهية لا يستطيع فقهاء المسلمين أن يقطعوا فيها برأيٍ صائبٍ، يبين الحل أو الحرمة فيها إلا بالاستعانة بعلماء مسلمين في مجال العلوم الحياتية، يكونون مهرة في مهنتهم، أكفاء في تخصصهم.
فإذا أخذنا علم الاقتصاد والتجارة -على سبيل المثال- كنموذج للدراسة، فهل يستطيع فقيهٌ مسلم غير متخصص أن يستنبط آراء فقهية صائبة في كل المعاملات الاقتصادية والتجارية؟! هل يستطيع أن يقطع بحل أو حرمة في قضية من قضايا التجارة وعلم الاقتصاد دون أن يكون على إحاطة تامة بأوجه المعاملات والمضاربات التي تتم في البنوك والبورصة والشركات والأسواق وغيرها؟!
بالقطع الإجابة هي النفي، خاصة وأن العلوم قد تشعبت كثيرًا، حتى أصبح داخل كل علم علومٌ أخرى كثيرة تتفرع منه وتنبثق عنه، ولكل فرعٍ من هذه العلوم متخصصون وباحثون ودارسون.
ثم وعلى فرض إمكانية أن يُدلي الفقيه بدلوه في مثل هذه القضايا ودون الرجوع إلى متخصصين فيه -وهو مستحيل وغير جائز- فما الحال إذا وجدنا مخالفة شرعية في مثل هذه العلوم؟ كيف يمكن إصلاحها وأسلمتها وفق المنهج الإسلامي؟! وكيف يمكننا أن نتعامل مع الأنظمة الاقتصادية العالمية المحيطة على ما بها من مخالفات، دون الوقوع في مخالفة شرعية؟!
ألا نحتاج في ذلك كله إلى اقتصادي متخصص؟! ألا نحتاج إلى من يدرس الاقتصاد بكل تفريعاته وعلومه، ويُلمُّ بكل تفصيلاته ودقائقه، ثم هو يدرس الفقه الإسلامي الخاص بالاقتصاد والتجارة، ثم يبدأ في صياغة الاقتصاد الإسلامي بالصورة التي تتناسب والعصر الذي نعيش فيه، ودون الوقوع في أدنى مخالفة شرعية؟!
ونستطيع أن نستشهد في ذلك بمثال واقعي في مجال الحقوق والقوانين، فقد كان الشهيد القاضي عبد القادر عودة من خريجي كلية الحقوق، وقد ألَّف كتابه "التشريع الجنائي الإسلامي"، والذي استطاع أن يُقدِّم فيه دراسة فقهية حول التشريع الجنائي في الإسلام وفلسفته ومقارنته مع القانون الوضعي، كما استطاع أن يُثبت بالأدلة والبراهين والحجج الدامغة محاسن الشريعة الإسلامية وتفوقها على القوانين الوضعية، مع سبقها إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية والنظريات العلمية والاجتماعية التي لم يعرفها العالم، والتي لم يهتد إليها العلماء إلا مؤخرًا.
ألا تحتاج الأمة في حياتها إلى مثل ذلك؟!!
أليست هذه ثغرةً إسلامية تحتاج إلى من يسدها ويقف عليها؟!
ثم أليس من يقوم بذلك يكون مأجورًا من الله تعالى على علمه وعمله هذا؟!
وهل يعتقد المسلمون المعظمون لدينهم أنهم لن يأثموا بترك هذا المجال وليس فيه متخصصون؟!
ألا يعتقد المسلمون أن دراسة الاقتصاد من هذا المنظور هو طريق مباشر من طرق الجنة؟!
والحقيقة أن الإجابة في ذلك لا تخفى على ذي عقل وصاحب لُبّ، وليكن في خلد الجميع أنه لن يقوم هذا الدين حقًا إلا بمبدعين في شتى مجالات وعلوم الحياة!!
وفي علم الطب -كنموذج ثانٍ للدراسة- نستطيع أن نقف أيضًا على نفس ما وقفنا عليه في علم الاقتصاد، من حاجة فقيه اليوم الماسة إلى طبيب مسلم متخصص، يساعده في تقرير فتواه فيما له علاقة ببعض جوانب الطب.
إذ كيف سيدلي عالمٌ شرعيٌ في قضايا دقيقة لها علاقة قوية بالطب، دون الاستعانة بطبيب مسلمٍ ماهر، يستطيع أن يشرح بدقة طبيعة الأمر في النقطة التي يحتاجها الفقيه؟!!
وكيف لنا أن نعرف حُكم الشرع في القضايا المستجدة وثيقة الصلة بالطب؟
كيف لنا أن نعرف حكم الشرع -مثلاً- في قضايا مثل "الاستنساخ" أو "زرع الأعضاء" أو "عمليات التجميل"، أو "أطفال الأنابيب" أو التداوي بما قد يتخلله مُحرَّم، وغيرها؟!
كل هذه الأمور وغيرها مما يستجد في حياتنا اليومية، نحتاج فيها -ولا شك- إلى أطباء مهرة في تخصصهم، ثم هم يدرسون في الشرع ما يختص بالفرع الذي يتقنونه، وبذلك يمتلكون القدرة على الإدلاء برأي صائب، يوافق بين رأي الطب ورأي الشرع.
أفلا يكون الطب من هذا المنظور طريقًا إلى الجنة؟! وهل يعذر المسلمون إذا لم يخرجوا لأمتهم أطباء يوضحون لهم هذه الأمور، ويبينوه للفقهاء، فيتمكنوا من الإفتاء بالحلال أو الحرام فيما يتعلق بهذه المسائل؟! فهذا -ولا ريب- بابٌ لابد من أن يتفوق فيه المسلمون، ليقيموا بذلك دينهم، وليطبِّقوه كما أراد الله تعالى.
ومن هذا المنطلق فهذه العلوم جميعًا، سواء أكانت علوم اقتصاد أو علوم سياسة أو علوم طب أو هندسـة، أو غيرها ممن هي على شاكلتها، وتنفع الأمة وتصلح الحياة للإنسان على الأرض. هي كلها علوم أُخروية، بشرط توفر النية الصالحة، والإخلاص لله عز وجل.
حاجة الإسلام إلى التفوق في علوم الحياة
هل من مصلحة الدعوة أن يكون حاملوها في ذيل أهل التخصص؟! سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، أو حتى على مستوى الأمة ككل؟!
وبصورة أوضح، إذا كان الطالب المسلم الملتزم بدينه غير متفوق في دراسته، ولم يكن سابقًا في علومه بين أقرانه، هل سيكون قدوة بين الطلاب، ومن ثم يقلدونه في منهج حياته، ويتبعونه في دعوته؟! وهل سيطمئن الآباء على أبنائهم في صحبتهم له؟!
إن من أخطر الأمور أن يتميز طالبٌ أو متخصصٌ بسمتٍ إسلامي ودعوي ظاهرٍ، ثم تخاله في مجال دراسته أو في تخصصه، أو حتى في مهنته -تخاله قليل العلم، أو ضعيف المستوي، أو بطيء الأداء، فهذه -ولا شك- دعوة سلبية، وهي دعوة إلى ترك هذا الدين الذي يلتزمه هذا المتأخر وذاك الضعيف، وذلك إما من أجل الخوف من أن يماثله في تأخره وضعفه، أو خوفًا من أن تتعطل أو تتعثر مسيرة العلوم..
وقد قال العلماء في تفسير قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [يونس: 85]، قالوا: إن معنى الدعاء في هذه الآية: أن لا تجعل الكافرين أعلى من المؤمنين وأعظم؛ فيفتن الكافرون بذلك، ويقولوا: لو كان هؤلاء على الحق ما نُصِرنا عليهم، ولو كانوا على الحق ما كانوا أضعف منا وأهون [8].
ولقد سمعت واحدًا من الأميركيين أسلم حديثًا يحمد الله أنه قرأ عن الإسلام واقتنع به قبل أن يرى حال المسلمين، وإلا لكانت فرصة إسلامه ضعيفة، والسبب أنه ربما لم تكن ستواتيه فرصة الاقتناع بهذا الدين الذي لا يدفع أصحابه -كما يعبر حالهم- إلى العلم والتقدم والعمل. لكنه -بفضل الله- كان قد قرأ عن الإسلام قبل أن يرى المسلمين، وعلم أنه يدعو إلى العمل ويحث على العلم ويحض على الفضيلة والمعاني الجميلة، وإعمار الأرض. وعلم أيضًا أن هؤلاء المسلمين الذين يراهم لا يمثلون حقيقة الدين الإسلامي، بل هم مخالفون لمبادئه، بعيدون عن تطبيق قوانينه.
والأمر في النهاية لا يخرج عن أن يكون فتنة؛ فكم من البشر صُدُّوا عن سبيل الله برؤية تأخر المسلمين هذا وبمعاينة تخلفهم وضعفهم؟!! أفلا يدعو كل ذلك المسلمين إلى النبوغ في مجالات العلوم الحياتية، تمامًا كما ينبغون في العلوم الشرعية؟! إن هذا -والله- لهو الحق الذي لا ريب فيه.
الإسلام يدعو على التفكير والإبداع
الإسلام بصفة عامة يحث على تكوين العقلية العلمية الموضوعية، التي تبني أفكارها على الاستدلال والاستنباط، وينكر تمامًا ذلك التقليد الأعمى، الذي لا يُنظر فيه إلى حجة، ولا يُهتم فيه بمنطق ولا برهان.
فتراه سبحانه ينكر على الكفار تبعيتهم العمياء لآبائهم فيقول: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} [الزخرف: 22].
وترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على المسلم أن يكون هملا إمعة لا رأي له ولا قرار، فيقول في الحديث الذي رواه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه: "لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً؛ تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ؛ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا" [9].
بل إن الله تعالى قد طلب البرهان من الكفار على كفرهم هذا وعنادهم فقال: {أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [النمل: 64]. وقال أيضًا: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الأحقاف: 4].
وقد عرض ربنا سبحانه وتعالى كل القضايا بمنطق الحجة والبرهان والدليل، فقال في إثبات وحدانيته سبحانه: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الأنبياء: 22].
وقال في موضع آخر: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} [المؤمنون: 91]. وقال: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}[لقمان:11].
وفي قضية البعث يقول سبحانه معدِّدًا الأدلة والبراهين والحجج العقلية: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ} [يس: 78 - 81].
وهكذا، فالإسلام يحث على استخدام العقل، وعلى التفكير الناضج، والفقه الواعي، بل إنه يعد الإنسان الذي عطَّل عقله أشبه بالحيوان، أو أحط قيمة منه!!
قال الله تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [الأعراف: 179].
فالإسلام إذن دينٌ يدعو إلى إعمال العقل، وتحريره من قيود التقليد والجمود والمحاكاة، وأن يطلق له العنان لأداء وظيفته وفق ضوابط معينة وأطر خاصة.
وعليه فإن الذي يُعطِّل عقله عن العمل والتفكير والإبداع، يكون قد خالف المنهج الإسلامي مخالفة جسيمة، وأضرّ بنفسه، ثم بأمته من بعده.
د.راغب السرجاني
[1] مسلم: كتاب الجنة ونعيمها وصفات أهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (2858)، والترمذي (2323)، وابن ماجه (4108)، وأحمد (18037)، وابن حبان (4330)، والطبراني في الكبير (713).
[2] الترمذي: كتاب الزهد، باب هوان الدنيا على الله عز وجل (2320)، وابن ماجه (4110)، والحاكم (7847)، وقال حديث صحيح، والطبراني في الكبير (5840)، والبيهقي في شعب الإيمان (10465)، وقال الألباني: صحيح (5292) صحيح الجامع.
[3] عبد الرءوف المناوي: فيض القدير 2/290.
[4] أحمد (13004)، والبخاري في الأدب المفرد (479)، وعبد بن حميد في مسنده (1216)، وقال الألباني: صحيح (1424) صحيح الجامع.
[5] عبد الباقي عبد الكبير عبد الواحد ولد عام 1970م في مدينة وردك بأفغانستان، حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية الشريعة والقانون في السودان، ويعمل حاليًّا بالجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية بمدينة زليتين، ليبيا، ومن مؤلفاته: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية.
[6] موقع إسلام أون لاين: استشارة إعمار الدنيا فريضة وضرورة للدكتور: عبد الباقي عبد الكبير.
[7] انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 1/ 109.
[8] ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 2/563. بتصرف.
[9] الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو (2007)، وقال: حديث حسن.





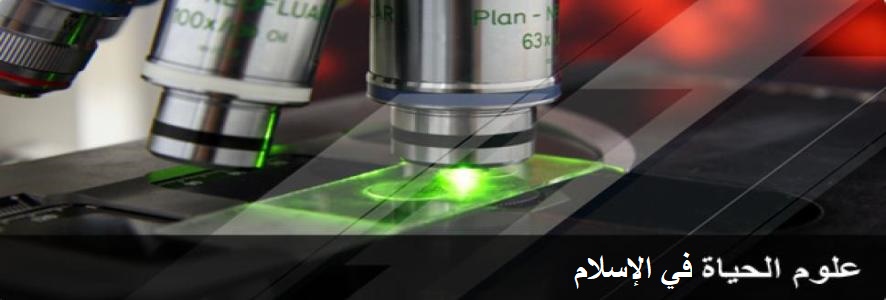
 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس