من المشرفين القدامى
ياجرح لا تقسى
تاريخ التسجيل: July-2011
الدولة: بيــن أوراقـــي
الجنس: أنثى
المشاركات: 4,761 المواضيع: 244
مزاجي: يمكن محتاره
المهنة: أخصائيه أجتماعيه في مجال الطب النفسي .. بلا وظيفة
أكلتي المفضلة: ااامممم مافي شي معين ^_ ^
موبايلي: Galaxy s Plus
آخر نشاط: 30/September/2019
۩ ۞ الـــدولــــــــة فــــــي نظـــــــر الإمــــــام علــــــي ( ع ) ۞ ۩
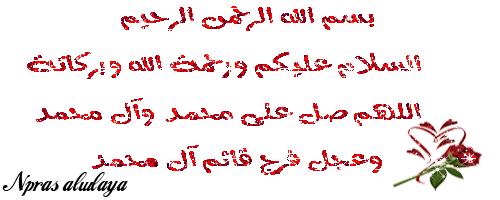
فلسفة الدولة عند الامام علي عليه السلام
د.نبيل ياسين
الدولة الحقوقية موضوع اجتهد الفلاسفة في تكريسه طوال عملهم الفلسفي من اجل الدولة فلسفة الحكم عند الامام علي
على ضوء مفاهيم الدول الديمقراطية المعاصرة
رغم ان كثيرا من الكتابات تناولت فلسفة الحكم عند الامام علي بن ابي طالب على ضوء الشريعة الاسلامية،فما تزال هناك حاجة ،في العصر الحديث، لدراسة فلسفة الحكم و تطبيقاتها لدى الامام على ضوء النظم الديمقراطية المعاصرة ، التي تقوم على مفاهيم وتطبيقات حقوقية ،مثل سيادة القانون واحترام حقوق الانسان و الانتخابات واحترام الرأي المعارض وحرية التعبير وتعددية الافكار و الشفافية واحترام المال العام و الفصل بين السلطات، و غيرها من مفاهيم حقوقية تقود الحياة السياسية في النظم الديمقراطية القائمة على مبدأ الاختيار الحر وتداول السلطة والاحتكام الى الدستور.
تشكل هذه المفاهيم صورة العالم المتقدم اليوم سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا.و هي تقوم على ما عُرف في الادبيات الاجتماعية والسياسية الحديثة بالعقد الاجتماعي بين المواطنين و الدولة، حيث تبلورت صورة المواطن الفرد باعتباره حجر الزاوية الذي يقوم عليه البناء الحقوقي و السياسي للمجتمعات الحديثة.و هذا يعني ان القانون يطبق من خلال تساوي جميع المواطنين،بمن فيهم افراد السلطة الحاكمة.اي ان القانون فوق الجميع وليس هناك احد فوق القانون.اما من ناحية عمل الدستور فليس هناك اجراء اكبر من الدستور. اذ ان كل الاجراءات يجب ان تكون دستورية. اي مطابقة لنصوص الدستور و تتمتع بالشرعية الدستورية التي يتفق عليها الجميع.
مثل هذه المفاهيم،كانت و ماتزال، القيم المرجعية لديمقراطية النظام السياسي.اي لكونه ممثلا لمصالح الغالبية من المواطنين الذين يستطيعون الحكم على هذا التمثيل من خلال الاعتراضات او الانتخابات او الاحتجاجات ،سواء من خلال التظاهر او وسائل الاعلام او التعبير عن الرأي.
يؤكد كثير من الباحثين و الكتاب المسلمين على ان الاسلام يحتوي على هذه القيم او اكثر منها لضمان العدالة و تمثيل السلطة لمصالح المسلمين و احترام شؤونهم و خصوصياتهم و تطبيق الشريعة باعتبارها تطبيقا لسيادة القانون و الدستور و ضمان حقوق جميع المسلمين .و بالتالي فليس هناك ديمقراطية اكثر من الديمقراطية التي ينادى بها الاسلام باسم الشورى.
غير ان هذه التأكيدات لا تصمد في تاريخ الحكم عبر اكثر من الف و اربعمائة سنة. صحيح أن الاسلام يتضمن مثل هذه الرؤية، ولكن تطبيقها لم يكن قاعدة و انما كان استثناء .و قد مثل هذا الاستثناء التطبيق الذي شهدته فترة حكم الخليفة الرابع علي بن ابي طالب. و سنبحث ذلك ، ليس فقط في النصوص و النظريات الخاصة بفلسفة الحكم و شرعيته التي وردت في خطب و احاديث و عهود الامام علي، و انما في التجربة التي استمرت اكثر من ثلاثين عاما و تلخصت في السنوات الاربع التي استغرقتها خلافة الامام.
كانت السقيفة بداية التجربة الديمقراطية التي خاضها فكر الامام علي السياسي المنبثق عن التصور الاسلامي و النص الاسلامي.فمنذ البداية كان هناك عدم وضوح لطبيعة (الامر) الذي تمت مناقشته في السقيفة. فوفاة الرسول(صلى الله عليه و آله) انهت واجبات النبوة و فتحت الباب امام واجبات من نوع جديد. وكانت المبررات التي ساقها عمر بن الخطاب لحصر (الامر) بيده في الواقع مبررات لصالح تبوء الامام علي موقع الخلافة مثل السبق الى الاسلام و القرشية و الهجرة و القرابة من الرسول. و بعد ان كانت نتيجة المجادلات في السقيفة خلافة ابي بكر بالطريقة التي تمت بها، كانت اعتراضات الامام علي تنصب على عدم اعطاء هذه الطريقة من التخليف الشرعية التي كان الامام علي يمثلها والتي جعلت ابا بكر و عمرا حريصين على الضغط على الامام علي لاعطائها لكي تأخذ الخلافة شرعيتها.
يقوم الفكر السياسي والاجتماعي الديمقراطي المعاصر على افكار و مفاهيم فلاسفة وكتاب و حقوقيين و سياسيين غربيين طوروا افكارهم و جعلوها قابلة للاعتناق و التنفيذ على مدى اكثر من ثلاثة قرون.و تتوزع هذه الافكار و المفاهيم على عدد واسع من هؤلاء الفلاسفة و الكتاب و الحقوقيين و السياسيين حيث اختص كل واحد منهم بتطوير واحد او اكثر من هذه المفاهيم و الافكار مثل الحرية و الفصل بين السلطات و التفاوت بين البشر و حقوق الانسان و حق المواطنة و العدالة و دور الدولة و الدين و الدستور و الحكم المطلق و المقيد و غيرها من افكار وم فاهيم المجتمعات و الدول الديمقراطية الغربية الراهنة.
غير ان ما يثير الانتباه هو اننا نرى فصلا في اغلب الاحيان بين منتجي هذه الافكار و بين مطبقيها، فانتاجها اقتصر في الغالب على الفلاسفة و الموسوعيين و الكتاب و الحقوقيين في حين اضطر الساسة لتطبيقها والاخذ بها بعد ان تحولت الى مرجعيات قانونية و حقوقية تضمنتها دساتير الامم الديمقراطية.
اما فيما يتعلق بالمفاهيم و الافكار التي تضمنتها الفلسفية السياسية و الاجتماعية للحكم لدى الامام علي، فاننا نرى ان هناك مصدرا واحدا مشتركا لانتاجها و تطبيقها هو شخص الامام علي نفسه.فهو يجمع بين انتاج الفكر الفلسفي و الحقوقي و الاجتماعي و بين ممارسته و تطبيقه من خلال عمل السلطة نفسها.
مفهوم الدولة والسلطة
يشكل مفهوم الدولة الذي صاغه التطور السياسي والاجتماعي الاوربي حين تحللت الامبراطوريات فوق الدولة و اصبحت الدول القومية الحيز الاول لممارسة السلطة.و في المفاهيم المعاصرة فان الدولة مفهوم ظهر في القرن السادس عشر و تبلور ضمن انسحاب الامبراطوريات الى حدودها القومية وبالتالي فانها نوع من التنظيم الاجتماعي القائم على قوة مادية. لذلك يقول اهرنغ(ان انعدام السلطة المادية هو الخطيئة المميتة للدولة)(الدولة -جاك دونديو دوفابر) ص6
غير ان التمادي في استخدام السلطة المادية يحول الدولة الى مستبد. و لذلك ظهرت افكار تنادي باقامة مؤسسات المجتمع المدني لتحد من هيمنة الدولة المادية على المجتمع.
ولذلك قال فولتير في (المعجم الفلسفي):لم اعرف حتى الان اي شخص لم يحكم دولة ما)(نفس المصدر-ص5) وهو يعني(ان جميع الناس الاخرين الذين يعرضون عند تناول العشاء او في مكاتبهم اسلوبهم للحكم و اصلاح الجيوش و الكنيسة و القضاء و المالية)(نفس المصدر)
هذا يعني ان الدولة و سلطتها امر يهم الجميع بما ان الدولة و السلطة تعنيان بامور المواطنين. و نجد تاكيد حق المواطنين في تناول امور الدولة في عهد الاشتر جيث يقول الامام علي( ثم اعلم يا مالك اني قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل و جور، و ان الناس ينظرون من امورك مثل ما كنت تنظر من امور الولاة قبلك ،يقولون فيك ما كنت تقول فيهم)(عهد الاشتر )ص27
يتجاوز هذا القول، قول فولتير.اذ ان فولتير يشير الى امكانية ان يكون موضوع الدولة امرا مختلفا عليه ، في حين يشير قول الامام علي الى حق المواطنين في نقد تصرفات الدولة من خلال تحقيق مصالحهم او عدم تحقيقها ، و بالتالي فان هناك تخصيصا للوظيفة الاساسية للدولة و هي تحقيق العدالة بمختلف اصنافها ، سياسية او قضائية او اجتماعية.
كما يعني قول الامام حق المواطن في التعبير عن رأيه في نقد الدولة و ممارساتها، و يذهب ابعد من ذلك حين يؤكد النص على ان الدولة تعبير عن مصالح مواطنيها و لذلك فانهم احرار في نقد سياسة الدولة اذا لم تعبر عن مصالح المواطنين. و هذا يجعل الدولة او السلطة تحت معيار الرقابة الشعبية كما يحدث في الدول الديمقراطية المعاصرة.
هذا على المستوى النصي النظري، و لكن الامام علي لا يتوقف عند محتوى النص، فهو حاكم مطبق لنصه و محتواه فعليا. فاثناء خلافته طبق الامام من خلال عدة احداث التزامه ، و هو الحاكم، بتطبيق بنود نصه و فكره و موقفه.ان حوادث واقعية كثيرة تثبت ذلك ، منها العقد الذي استعارته ابنته من خازن بيت المال و وقوفه مع اليهودي الذي رهن لديه درعه و اعتراضه على تمييزه من قبل القاضي بتكنيته ،و قبوله النقد الموجه اليه من مواطنيه و موقفه من الخوارج كمعارضة لها الحق في الاعتراض السلمي و نقد السلطة.
ان افكار و مفاهيم عدد من الفلاسفة والكتاب و التنويريين كانت اساسا للتحولات السياسية الكبرى نحو الديمقراطية التي قامت على انتاجهم الفلسفي والفكري مثل جون لوك (1632-1704) الانجليزي، و ديفيد هيوم(1711-1776) الاسكتلندي، و هيغل(1770-1831)الالماني، و توماس هوبز(1588-1679) الانجليزي و جون ستيورات مل(1806-1873) الانجليزي و مونتسكيو(1689-1755) الفرنسي.و غيرهم





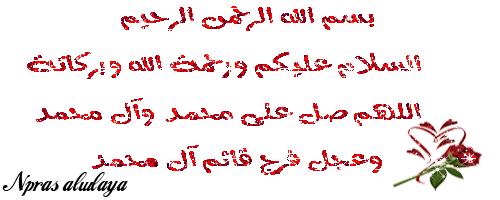
 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس