التاريخ هو الحضارة في أحد معانيه؛ فالتاريخ والحضارة مترادفان يحملان معنى واحدًا، فالتاريخ يحمل قصة الإنسان في الكون، ورحلته عبر الزمان، وهي رحلة ما تزال مستمرة. كانت خطوات الإنسان الأولى في مسيرته التاريخية هي نفسها خطواته الأولى في محاولة بناء الحضارة؛ ولهذا السبب كانت رحلة الإنسان، ورحلة تاريخه، ورحلة حضارته واحدة. ولهذا السبب كانت رحلة المعرفة التاريخية، أو «تاريخ التاريخ» موازية لرحلة الإنسان عبر الزمان. ومن ناحية أخرى، كانت الحضارة هي ما أنجزه الإنسان على المستوى المادي واللامادي على امتداد هذه الرحلة وحتى الآن.
التاريخ في أبسط معانيه قصة الإنسان وقصة محاولاته لإعمار الأرض وكشف حقائق الكون. وفى زمن البدايات لم يكن الإنسان يعرف حقائق الكون الذي عاش في رحابه، لم يكن قادرًا أيضًا على فهم الظواهر التي تحيط به في هذا العالم، ولم يكن قادرًا على التحرر من أسر الطبيعة؛ فعاش تحت رحمتها.
وفى ذلك الزمان كانت الأسطورة بمثابة الحل العقلي والنفسي لعجز الإنسان وجهله؛ فظهرت الأساطير التي تتحدث عن نشأة الكون، ومظاهر الطبيعة، وأصل الإنسان … وما إلى ذلك. وفى تلك المرحلة أيضا كانت «المعرفة التاريخية» بدائية وساذجة؛ فلم يكن الإنسان يعرف كيف يسجل ماضيه أو يحتفظ بذاكرة تاريخية عن هذا الماضي.
وهنا كانت الأسطورة أيضًا الحل العقلي والنفسي لمعالجة النقص في الذاكرة التاريخية البشرية، وترقيع الخلل في هذه الذاكرة. وعلى مستوى مسيرة البشر الحضارية كانت الذاكرة التاريخية الساذجة المشوشة والمحاولات البدائية من جانب الإنسان الأول لصنع أدواته وأسلحته، وبناء مسكنه، وتأمين غذائه، وتنظيم الجماعة البشرية، متوازية مع تلك المرحلة من تاريخ الإنسان ومن تاريخ التاريخ. لقد كانت بمثابة الضلع الثالث في مثلث يجسد تاريخ الإنسان في الكون عبر الزمان؛ قصة الإنسان وقصة حضارته في آن معًا.
كان الإنسان في بداياته الأولى، وكان تاريخ الإنسان في بداياته الأولى أيضًا، ومن ثم كانت «الحضارة» الإنسانية بدائية ساذجة، فقد كان كل تطور يحدث في مسيرة الإنسان الحضارية يوازيه تطور في مجال المعرفة التاريخية. وتفسير ذلك أنه على مستوى الحضارة كان التطور يترك آثاره المادية واللامادية: مرحلة بعد أخرى، من الجمع والالتقاط حتى بناء المدن والمجتمعات، ومن البحث عن الغذاء إلى استئناس النبات والحيوان وتحقيق الفائض في الغذاء وظهور الحرف والصناعات، ومعرفة التخصص بين قطاعات الجماعة البشرية، وظهور العبادات، وتنظيم الحكومات. وعلى مستوى الفكر التاريخي كان التطور ينقل المعرفة التاريخية من مرحلة نوعية إلى مرحلة نوعية جديدة، وهو ما يجعلنا نقول إن التاريخ هو الحضارة في أحد معانيه. ويلفت النظر هنا أن الأسطورة كانت تحكم إنسان ذلك الزمن البعيد وتشكل تاريخه من ناحية، وأن المعرفة التاريخية كانت واقعة تحت سيطرة الأسطورة من ناحية أخرى.
لقد كان الفكر التاريخي رفيقًا ملازمًا للإنسان في كل زمان ومكان. ولذلك فإنه عندما عاش الإنسان الأول على الأسطورة التي عوضت نقص معرفته ورقعت ثقوب ذاكرته، كان فكره التاريخي أسطوريًا؛ فقد ولدت المعرفة التاريخية في رحم الأسطورة، وكبرت في حجرها عندما كان الإنسان بحاجة إلى هذا النوع من «القراءة الأسطورية» لتاريخه. ولهذا السبب فإن من يقرأ الأساطير الأولى عند الشعوب يجدها تدور حول نواة تاريخية، أو يجد فيها الكثير من «التاريخ» ومن يقرأ الكتابات التاريخية الباكرة يجد فيها الكثير من العناصر الأسطورية.
وفى هذه التواريخ/ الأساطير أيضًا نجد بدايات الحضارة الإنسانية الباكرة في جوانبها الفكرية والثقافية؛ فقد حملت هذه التواريخ/ الأساطير الإجابات التي توصل إليها الإنسان في بحثه عن أصول الجماعات البشرية، وهويتها الحضارية، فضلًا عن أصول الأشياء والظواهر التي شاهدها الإنسان في الكون.
هكذا كان التاريخ مفهومًا حضاريًا منذ البدايات الأولى. ففي تلك المرحلة الباكرة من تاريخ الإنسان، وتاريخ التاريخ، نجد محاولات أسطورية لتفسير الوجود الإنساني في الكون، وحل اللغز المتعلق بهذا الوجود. وفى تلك المرحلة، أيضًا نجد محاولات أسطورية لتبرير سلطة الحكام والملوك الذين نسبتهم الأساطير إلى الآلهة والديانات التي ابتكرها البشر. فقد نسبت تلك التواريخ/ الأساطير حكام ذلك الزمان إلى حكومات الآلهة، كما نسبت إليهم الفعاليات التاريخية ولم تترك للإنسان سوى دور المفعول به.
لقد كانت تلك مرحلة «تاريخية» تتوازى مع تلك المرحلة «الحضارية» من حيث بساطتها وسذاجتها ومن حيث أن قوامها كان الأسطورة والخرافة. أي أن حضارة الإنسان في تلك الأزمنة البعيدة كان قوامها البحث عن وسائل مادية للسيطرة على الكون الذي يعيش الإنسان في رحابه من ناحية، والبحث عن وسائل ثقافية تبرر الوجود الإنساني وتفسره من ناحية أخرى. وفى ذلك الزمان أيضا كان التاريخ يدور حول «نواة تاريخية» واقعية يغلفها الخيال وتحتضنها الأسطورة. وهو ما يبرر ما نزعمه أن التاريخ والحضارة مترادفان على نحو ما. التاريخ هو قصة الإنسان في الكون والحضارة هي إنجاز الإنسان في الكون.
التاريخ قصة الإنسان في الكون، وسيرته في هذا العالم، ورحلته عبر الزمان. والحضارة تجسيد لهذا كله على المستوى المادي واللامادي عبر القرون. وإذا كان مؤرخو الحضارات يجمعون على أن جميع حضارات الإنسان، منذ البداية حتى الآن، قد أخذت عن الحضارات التي سبقتها- باستثناء الحضارات الأولى التي حددها البعض مثل أرنولد توينبي بعدد معين في وديان الأنهار في مصر والعراق والصين والهند- فإن معنى هذا في التحليل الأخير أن تاريخ الحضارة متصل الحلقات متواصل المراحل شأنه في ذلك شأن تاريخ الإنسان صانع الحضارة أيضًا.
وإذا كان الإنسان هو صانع التاريخ فهو أيضًا صنيعة هذا التاريخ، بمعنى أنه يصنع تاريخه حقًا؛ ولكنه يتشكل بفعل هذا التاريخ أيضًا. ومن ناحية أخرى فإن الإنسان صانع الحضارة ونتاجها في الوقت نفسه. ومن ثم فإن التاريخ يحمل مفهومًا حضاريًا، كما أن الحضارة تحمل مفهوما تاريخيًا.
واللافت للنظر حقًا أن المؤرخين والباحثين وعامة المفكرين والمثقفين يتفقون على أن التاريخ علم موضوعه الماضي الإنساني. ولما كانت الحضارة محصلة ما أنجزه الإنسان في الماضي- وهو ما يصدق على الحضارات القديمة والحضارات المعاصرة بالقدر نفسه- فإن الماضي عنصر يجمع بين التاريخ والحضارة. فالحضارة بناء تاريخي متراكم فيما يشبه الطبقات الجيولوچية، ويحمل بصمات وآثار التفاعل والتواصل المستمر بين الحضارات الإنسانية الأخرى؛ بغض النظر عن عبثيات «نهاية التاريخ» و» صدام الحضارات»، و «العولمة».
تاريخ البشرية واحد؛ ولكن تجليات هذا التاريخ مختلفة متباينة من زمن إلى زمن آخر ومن مكان إلى مكان مختلف، ومن أمة إلى أمة غيرها. والحضارة الإنسانية واحدة ولكن تجلياتها مختلفة أيضًا. وآية ذلك أنك لن تجد أمة لها تاريخ منعزل تمامًا عن تاريخ الأمم الأخرى، ولن تجد حضارة لم تأخذ عن حضارة سابقة، أو معاصرة، أو مجاورة، صحيح أن لكل أمة تاريخًا خاصًا بها ويحمل بصمات هويتها الحضارية، وصحيح أيضا أن لكل أمة حضارة شادتها عبر تاريخها؛ بيد أنها جميعًا تبدو مثل روافد تصب في مجرى نهر واحد هو التاريخ الإنساني والحضارة الإنسانية.
ويلفت النظر هنا أن الجوانب السياسية والعسكرية في التاريخ، أو في الحضارة إن شئت، هي عوامل الفرقة والتفرقة والتباعد والتخاصم. فالأطماع السياسية والأنشطة العسكرية، كانت باستمرار من أسباب التباعد والنزاع؛ ولكن العوامل الفكرية والثقافية في التاريخ وفى الحضارة على السواء كانت هي عوامل التقارب والتفاعل والمشاركة؛ وكانت على مدى الزمان تنتقل من شاطئ إلى آخر في سهولة ويسر، هذا هو مفهوم الحضاري في التاريخ، أو المحتوى التاريخي في الحضارة.
وربما أن التاريخ في معناه النهائي الشامل استجابة لمحاولة الإنسان معرفة ذاته (على المستوى الفردي والجماعي)، ومعرفة علاقة الإنسان بالآخر في عالمه، فإن التاريخ بوصفه علمًا، دراسة إنسانية/ اجتماعية تؤكد على أهمية الإنسان، واختياراته الفردية والاجتماعية، وعلى النظام الأخلاقي والقيمي الذي يحكم الفرد والجماعة البشرية، فضلاً عن رؤية الذات، والآخر في هذا العالم؛ ومن هنا فإن التاريخ من أكثر العلوم ارتباطًا بالإنسان. فالتاريخ يلهث وراء الإنسان من عصر إلى آخر محاولاً أن يفهم الإنسان، وأن يُفهم الإنسان. حقيقة الوجود الإنساني في الكون، ووسيلته في ذلك البحث في أحوال البشر الماضية من أجل تحقيق معرفة الإنسان بذاته باعتبار ذلك المدخل إلى معرفة الإنسان بالكون في الحاضر وفى المستقبل. ودراسة أحوال البشر في الماضي ليست في حقيقة الأمر سوى دراسة المفهوم الحضاري لمسيرة الإنسان ورحلته في رحاب الزمان.
وهنا نجد سؤالاً يطرح نفسه في إلحاح؛ ترى هل هناك ضرورة للمعرفة التاريخية في حياة البشر؟ وهل هناك وظيفة حضارية للتاريخ؟
إن بوسعنا الزعم بأن للتاريخ ضرورة اجتماعية تقوم على أساسها وظيفته الحضارية. بمعنى أن كل جماعة بشرية بحاجة إلى المعرفة التاريخية التي تساعدها على معرفة ماضيها؛ أي أصولها التي تعينها على فهم مكونات حاضرها؛ واستشراف الطريق إلى مستقبلها. وفى رأى بعض الباحثين أن هذه الرغبة في المعرفة التاريخية تكاد تقترب من الرغبة الغريزية التي تدفع العقل البشرى لطرح السؤال المدهش عن الوجود الإنساني والمصير الإنساني في هذا الكون.
والحقيقة أن اهتمام الإنسان بالتاريخ إنما يرجع إلى رغبة الإنسان في الكشف عن لغز الوجود الإنساني ومعرفة الذات التي هي أولى الخطوات على طريق المعرفة الحقة. وليس من الممكن معرفة خصائص الطبيعة البشرية دون دراسة أفعال البشر وفحصها في سياقها الاجتماعي. إننا ندرس التاريخ للسبب نفسه الذي يدفعنا إلى دراسة أي موضوع آخر يتعلق بالإنسان؛ أي الرغبة في الوقوف على أسرار لغز الوجود الإنساني. بيد أن دراسة التاريخ لا يمكن أن تعتمد على دراسة الإنسان الفرد؛ وإنما يجب دراسة الإنسان في السياق الاجتماعي. ومن هنا يجب دراسة الذاكرة الجامعة للجنس البشرى؛ أي دراسة التاريخ.
وهذا هو المفهوم الحضاري للتاريخ؛ فمن المؤكد أننا نخرج من دراسة التاريخ بحقيقة واضحة مؤكدة هي أن تجربة الإنسان في الكون تكشف لنا عن حقيقة التنوع والثراء الذي تتسم به الحياة الإنسانية في سياقها الاجتماعي، وإطارها الحضاري، ولكننا نكتشف أيضا أن لكل جزء في الحياة الإنسانية على مرّ التاريخ خصائصه الداخلية التي تجعلنا نقول إن هذا تاريخ الصين، أو تاريخ المسلمين، أو تاريخ الهند … وما إلى ذلك.
وهو ما يجعلنا نسمى الحضارات بأسماء مختلفة مثل الحضارة المصرية، أو الحضارة الإغريقية، أو الحضارة العربية الإسلامية… وهكذا. وعلى الرغم من هذا التنوع والثراء من ناحية، وعلى الرغم من التباين والاختلاف بين الأجزاء من حيث خصائصها الداخلية من ناحية أخرى، فـإن هناك تاريخًا واحدًا يجمع الجنس البشرى؛ وهناك حضارة إنسانية واحدة تزداد خصائصها العامة والمشتركة مع مرور الزمان.
يعلمنا التاريخ في مفهومه الحضاري، أنه أيًا كانت جاذبية التشابهات بين الماضي والحاضر، فإن الماضي لا يعود أبدًا؛ أي لا يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه. ولكن هذا، من ناحية أخرى، لا يعني أن التاريخ قصة تنتمي إلى الماضي الذي انتهى. فالتاريخ لا يحكى ما حدث في الماضي فحسب، وإنما يفسره بأن يقدم لنا أسباب الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية … وغيرها مما حدث في الماضي الإنساني؛ وما خلفته تلك الظواهر من نتائج.
ونكتشف من دراسة التاريخ أن لا شيء يحدث بالصدفة، وأن لا شيء يمضي عبثًا: فلكل حادث تاريخي أسبابه ونتائجه. كذلك يعلمنا التاريخ ألاَّ نركن إلى النمطية، وألا نتصور أن ما نجح من قبل سوف ينجح ثانية، أو أن ما فشل وأخفق في الماضي سيكون الفشل مصيره في المستقبل أو في الحاضر: ذلك أن السببية تحكم مجرى التاريخ. إنها سنة الله في خلقه التي لن تجد لها تبديلاً.
ويعلمنا التاريخ، أيضًا، أن نتذكر على الدوام أننا بشر نتحرك في رحاب المكان وداخل إطار الزمان. ولأن دراسة التاريخ تهتم بثلاثية الإنسان والمكان والزمان، كما تهتم بالعلاقة السببية؛ فإنها توسع من مدى إدراكنا لحقائق الفعل التاريخي الذي ينتج عنه البناء الحضاري في أي مجتمع من المجتمعات البشرية. وليس معنى هذا على أية حال أن معرفة التاريخ أو دراسته سوف تدلنا ببساطة على ما يجب أن نفعله بالضبط؛ ولكن المعرفة التاريخية ربما تساعدنا على تجنب تكرار الأخطاء.
إن التاريخ يمكن أن يعلّم وينبه ويحذر؛ ولكن لا يستفيد من التاريخ سوى من يحسنون الاستماع إليه. ولسنا نزعم أن التاريخ يقدم حلولًا للمشكلات؛ ولكن المعرفة التاريخية تجعلنا نقف على الأسباب، وزمن وقوع الحدث التاريخ، وكيفية حدوثها. فالتاريخ يدرس الماضي بسبب الرغبة في المعرفة التاريخية التي كانت تلازم الإنسان منذ بداية رحلته في الكون بشكل يكاد يكون غريزيًا؛ إذ إن الإنسان جبل على السعي لعرفة الأصول: أصول الكون ومظاهره، أصول الوجود الإنساني نفسه، وأصول الظواهر الاجتماعية، والثقافية التي يعيش في إطارها وعلى الرغم من أن الأسطورة، والدين، والفلسفة جميعًا، حاولت تقديم الإجابات عن الأسئلة المتعلقة بالأصول على نحو أو آخر، فإن الأسئلة المتعلقة بالمصير (لماذا؟ وإلى أين؟) ما تزال تحير الإنسان وتربكه إلى الآن.
والتاريخ إحدى الوسائل التي يتوسل بها الإنسان لفهم كينونته الحضارية في هذا العالم. ولا تقتصر هذه الوسيلة على الماضي الذي يدرسه التاريخ وحده، وإنما تمتد إلى رحاب الحاضر لتستكشف آفاق المستقبل. وهكذا تحددت منذ البداية قيمة المعرفة التاريخية بوظيفتها الثقافية/ الاجتماعية، ومفهومها الحضاري. وليس من المتصور، بطبيعة الحال، أن هذه الوظيفة كانت واضحة لدى الجماعات البشرية الباكرة بدرجة وضوحها الحالية بيد أن إحساس الجماعة الإنسانية بالحاجة إلى هذا النمط من المعرفة كان موجودًا على الدوام. ومع تطور مراحل رحلة الإنسان في الكون عبر الزمان تطورت أيضا المعرفة التاريخية ودورها الحضاري. فقد اجتاز علم التاريخ مرحلة التراكم الكمي والسرد لكي يدخل في طريق محاولة صياغة النظريات واكتشاف القوانين التي تفسر حركة الإنسان في الكون. وعلى الرغم من أن العلم التاريخي لم يتخلْ تمامًا عن الكم والسرد؛ فإن محاولة صياغة النظريات واكتشاف القوانين هي نفسها محاولة البحث في أسباب قيام الحضارة وانهيارها. لقد انتقل علم التاريخ من محاولة الإجابة على سؤال «ماذا حدث؟ « إلى محاولة الإجابة عن سؤال : «لماذا حدث ما حدث؟ وكيف؟».
ومن هنا تنوعت مدارس فلسفة التاريخ التي تصوغ موضوعاتها على أساس المعرفة التاريخية، وتفسير هذه المعرفة تفسيرًا وضعيًا، وعلى أساس فهم حياة البشر في سياقها الاجتماعي في محطاتها الزمنية المختلفة من خلال معايير تنطوي على المفهوم القيمي والأخلاقي تارة، والتقييم الموضوعي النقدي تارة أخري، أو الجمع بين هذا وذاك تارة ثالثة. وهذا التفسير بتنويعاته المختلفة هو أيضا الذي حاول فهم الحضارة الإنسانية بدرجات متفاوتة من النجاح والإخفاق. وقد نتجت عن محاولات التفسير هذه نظريات كثيرة عن نشوء الحضارة وانهيارها: بدءًا من محاولة المؤرخ المسلم عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته الشهيرة، ومرورًا بالنظريات الأوربية المختلفة التي قال بها فلاسفة ومؤرخون مثل مشاهير الماركسيين، وغيرهم من أمثال شبنجلر الذي يبدو في نظريته مستلهما آراء ابن خلدون، وأرنولد توينبي صاحب نظرية التحدي والاستجابة التي ضمنها كتابه المدهش «دراسة للتاريخ» وصولا إلى النظرية العبثية العابثة التي قال بها الأمريكي فرانسيس فوكاياما عما أسماه «نهاية التاريخ».
هذا كله يؤكد أن مفهوم «الحضاري» الذي يلازم العلم التاريخي ويلتصق به، حقيقة كانت موجودة على امتداد «تاريخ التاريخ». وربما يكون مفيدًا في هذا المقام أن نقرر أن نمط المعرفة التاريخية قد ارتبط ارتباطا عضويا بالحضارة التي أفرزته على الدوام. فقد كانت المعرفة التاريخية في كل حضارة تتناسب مع هذه الحضارة في درجة تطورها من ناحية، كما كانت تعبيرًا عن رؤية هذه الحضارة للذات والآخر من ناحية ثانية. ذلك أن المعرفة التاريخية، في حقيقة أمرها، نوع من التبرير الإيديولوچى لوجود الجماعة البشرية التي تنتمي إليها: أي أنها إحدى وسائل الجماعة البشرية في التعبير عن هويتها الحضارية، وتبرير وجودها نفسه. فلكل جماعة بشرية وعيها التاريخي الذى يناسب حضارتها؛ أي تاريخها.
وهنا تبدو المركزية الغربية، التي ورثت المركزية الأوربية، عنصرية عندما يقرر مفكروها وفلاسفتها في القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين أن التاريخ لم يوجد سوى في الغرب الأوربي. بل إن مفكرًا مثل هيجل وصف الشعوب الآسيوية والأفريقية بأنهم "قومًا بلا تاريخ"، كما وصم "ليوبولد ڤون رانكه" هذه الشعوب بأنها "قوم جامدون إلى الأبد". لأن الغرب لم يعترف بوجود أنماط حضارية أخرى خارج أوربا، وعلى الرغم من أن هناك محاولات بدأت على استحياء في الغرب لدراسة التراث التاريخي خارج أوربا منذ النصف الثاني من القرن العشرين، فإن المركزية الغربية ما تزال قوية في دوائر التاريخ والمؤرخين في الغرب بشكل عام.
وعلى أية حال، فإن لكل جماعة نمط المعرفة التاريخية الخاص بها، والذي يعكس الخصائص العامة لحضارتها. ومن ثم؛ فإن مفهوم الحضاري الكامن في المعرفة التاريخية يتجلى واضحًا في التاريخ الثقافي لجميع الحضارات. ولأن الحدود التي تحكم موضوع هذه الورقة محدودة من حيث الوقت والمساحة؛ فإننا سوف نقدم مثالاً واحدًا على تلازم مفهوم الحضاري والمعرفة التاريخية. وهو الوظيفة الحضارية للتاريخ في الثقافة العربية الإسلامية.
كان تطور الفكر التاريخي في إطار الثقافة العربية الإسلامية قائمًا على أسس ثلاثة واضحة:
1- تراث المعرفة التاريخية في المنطقة العربية قبل الإسلام.
2- ما جاء به الإسلام من فكر يدور حول المادة التاريخية الواردة في القرآن الكريم.
3- وما جاءت به اللغة العربية نفسها من أساليب التعبير، وما تركته من أثر على طرق التفكير.
وبعد أن اعتنق العرب الإسلام حدثت تغيرات جوهرية في شتى نواحي الحياة، وبعد نجاح حركة الفتوح الإسلامية، غلبت تلك التغيرات على شكل الحياة في المنطقة العربية بشكل عام. وكان لابد لفكرة التاريخ عند المسلمين أن تخضع لهذه التطورات الجديدة. مع أن تراث المعرفة التاريخية لدى شعوب المنطقة التي دخلت في دين الإسلام ظل موجودًا بشكل أو بآخر؛ فإن الفكرة القرآنية عن التاريخ، والظروف الموضوعية الجديدة التي خلقتها التطورات السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، أدت بطبيعة الحال إلى نقله نوعية في مفهوم الحضاري في المعرفة التاريخية صارت صفة لازمة للفكر التاريخي في إطار الحضارة العربية الإسلامية.
وقد حدثت النقلة في مفهوم الحضاري على مستويين:
أولهما مستوى فكرة التاريخ عند المسلمين التي تطورت من خلال المفاهيم القرآنية عن المادة «التاريخية» الواردة في القرآن الكريم.
وثانيهما مستوى الظروف الموضوعية التاريخية على أرض الواقع.
وقد أدى التفاعل بين ما جاء به القرآن الكريم من أفكار حملتها الآيات ذات المضمون التاريخي حول دور الإنسان في الكون من ناحية، وما ورثته شعوب العالم الإسلامية من خبرات تاريخية عن ماضيها من ناحية ثانية، والتطورات التاريخية الموضوعية الجديدة من ناحية ثالثة، إلى تبلور مفهوم جديد حضاري للتاريخ.
وعند المستوى الأول نجد أن فكرة التاريخ في القرآن الكريم تجسيد للتصور الإسلامي لرسالة الإنسان في الحياة؛ فالإنسان خليفة الله في الأرض، وقد حمل أمانة إعمار الأرض وبناء الحضارة، ونشر الحق والعدل في ربوعها وفق سنة الله. والشرط الجوهري الذي مكن الإنسان من القيام بدوره أن يعرف ذاته؛ فقد جاء في سورة آل عمران {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138)} [آل عمران: 137، 138]. وهذه الدعوة إلى معرفة الذات يمكن أن يلبيها الإنسان من خلال رصد حوادث الماضي، وتأمل ما جرى فيه من أحداث بقصد معرفة سنة الله التي هي قانون الكون الذي لا يتبدل.
وهنا يبدو واضحًا أن فكرة التاريخ في القرآن الكريم محورها أن أحداث التاريخ أفعال بشرية، وأن الإنسان مسئول عنها بحكم قبوله حمل الأمانة التي خشيت من حملها الأرض والسموات والجبال. فالفعل التاريخي نتاج لتفاعل الإنسان مع معطيات البيئة وتحدياتها في رحاب الزمان. ومن ناحية أخرى، فإن هذا الفعل خير وسيلة للتعرف على الإنسان في حياته الاجتماعية ومسيرته التاريخية: أي حضارته. ومن ثم، فإن «القصص» التي ترد في القرآن الكريم تحكى: «تواريخ» الأمم والأقوام والحضارات التي مرت بتاريخ البشرية عبر الزمان. وفى هذا القصص نجد مادة تاريخية، وإن كانت غير تفصيلية، تحكى عن السابقين من البشر. بيد أن هدف هذه القصص التاريخية وغاياتها إثارة الفكر البشرى، ودفعه إلى التفكير والتساؤل والتبرير.
هذا التغير الجوهري في النظر إلى المادة التاريخية أدى بالضرورة إلى تغير جوهري في مفهوم «الحضاري» في الفكر التاريخي الإسلامي. ذلك أن فكرة التاريخ في القرآن الكريم تجعل الإنسان مسئولاً عن تصرفاته «التاريخية»؛ أي في سياقها الاجتماعي (مثلما هو مسئول عن تصرفاته الفردية). ومعنى هذا النزول بالتاريخ إلى عالم الواقع الوضعي: أي أن «التاريخ» بدأ يبحث عن الأحداث التاريخية التي صنعها البشر في بيئتهم. لقد تغير مفهوم الحضاري في فكرة التاريخ عند المسلمين، وراح المؤرخون المسلمون يبحثون في قصة الإنسان على الأرض. فالمادة التاريخية الواردة في القرآن الكريم تقوم على أساس أن للتاريخ معنى أخلاقيًا وروحيًا على اعتبار أن الإنسان خليفة الله في الأرض ومسئول عن إعمار العالم وإقامة الحق والعدل فيه. وفى هذا الصدد نجد الكثير من الآيات القرآنية التي تؤكد على فكرة أن تاريخ الإنسانية بمثابة مستودع للعظات والعبر. ومن السور القرآنية التي تحمل هذا المفهوم: هود، والأعراف، والأنباء، والمؤمنون، والشعراء والقصص.
ومن هنا فإننا لا يجب أن نندهش من أن المفهوم الحضاري للتاريخ عند المؤرخين المسلمين لم يخلْ من الجانب الأخلاقي المتصل بالعقيدة في أساسه. فقد قرأ المؤرخون المسلمون التاريخ «قراءة دينية-أخلاقية- تربوية» ؛ وهو ما جسده عبد الرحمن بن خلدون بقوله : «… اعلم فن التاريخ فن عزيز المذهب ، جم الفوائد، شريف الغاية : إذ هو يوقفنا على أحوال الماضيين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء بهم في ذلك لمن يروقه في أحوال الدنيا والدين …» هذا هو مفهوم الحضاري في التاريخ كما أوضحه ابن خلدون الذى كانت مقدمته الشهيرة بمثابة تلخيص للفكر التاريخي الإسلامي وفلسفته. وقد ظل المؤرخون المسلمون يعملون في إطار المفهوم القرآني للدور الحضاري للتاريخ في المجتمع المسلم؛ بل إن منهم من تحدث عن «فوائد التاريخ» وقسمها إلى قسم دنيوي وآخر أخروي مثل ابن الأثير الذي يرى أن القصص التاريخية التي وردت في القرآن الكريم إنما وردت لهذه الحكمة.
لقد وصل تطور الكتابة التاريخية في القرن التاسع/ الخامس عشر الميلادي إلى مرحلة غطت فيها كافة مجالات النشاط الإنساني تقريبا. فقد كتب المؤرخون المسلمون في السيرة النبوية، والمغازي، والطبقات (أي أجيال الناس الذين أسهموا في خدمة الأمة من أبناء مهنة واحدة، أو ممن يشتركون في ممارسة فكرة بعينها)، والتراجم، والتاريخ الإسلامي العام، وفضائل البلدان، والفتوح ، والخطط ، وتواريخ المدن، والتاريخ الاجتماعي ولا تكاد تجد فرعًا من فروع المعرفة التاريخية إلا وكتب فيه المؤرخون المسلمون؛ وفضلاً عن ذلك أنتج الفكر التاريخي الإسلامي بعض من كتب في تاريخ التاريخ (من أمثال شمس الدين السخاوى، والكافيجي، والذهبي، والسيوطي)، وفى فلسفة التاريخ (مثل ابن خلدون). وهذه الحقيقة بحد ذاتها تكشف عن أن مفهوم الحضاري في التراث التاريخي عند المسلمين قد اتسع ليشمل بالفعل كافة أنماط النشاط الإنساني.
والعصر الذي يبدو متحفا يضم كافة أنماط التدوين التاريخي في الحضارة العربية الإسلامية هو عصر سلاطين المماليك (648-922هجرية / 1250-1517م). والواقع أن دولة سلاطين المماليك التي حكت مصر وفلسطين والشام والحجاز وبعض مناطق العراق وجزر البحر المتوسط بشكل مباشر، والتي كانت قوة إقليمية وعالمية عظمى في ذلك الزمان، قد شهدت نشاطًا علميا وفكريًا واسع النطاق بسبب ظروف العالم الإسلامي التي جعلت العلماء والمفكرين من المشرق والمغرب يهاجرون إلى بلاد الدولة المملوكية حيث الأمان. لقد كان التوهج العلمي والثقافي الذي شهده ذلك العصر المتوهج الأخير في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. وفى ذلك العصر، تجسد مفهوم «الحضاري» في مجال الفكر التاريخي بشكل متكامل. فقد تنوعت أنماط الكتابة التاريخية كما أوضحتا من قبل؛ كما استخدم التاريخ في خدمة المجتمع وتلبية حاجاته الثقافية الاجتماعية.
وفى العصر الحالي نجد في مواجهتنا سؤالاً يطرح نفسه بإلحاح: هل لدينا منظور حضاري للتاريخ؟
إن قراءتنا الحالية للتاريخ قراءة ماضوية تهرب من مواجهة مسئوليات الحاضر والمستقبل لدغدغة مشاعر الزهو الكاذبة بإنجازات الماضي الذي نبدده في سفه سياسي وثقافي مزعج. وبسبب الأجواء الخانقة سياسيًا والمعطلة للحرية والمانعة تخبو جسارة الإبداع، وتخفت القدرة على قراءة تاريخنا قراءة واعية؛ بل إن التاريخ مطارد في مدارسنا وجامعاتنا.
إن الحرية شرط جوهري للإبداع، وعندما تنزاح النظم المستبدة الجاثمة على الحياة في العام العربي، ربما يتحقق ما نصبو إليه من «قراءة حضارية» للتاريخ.[1]
دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية.





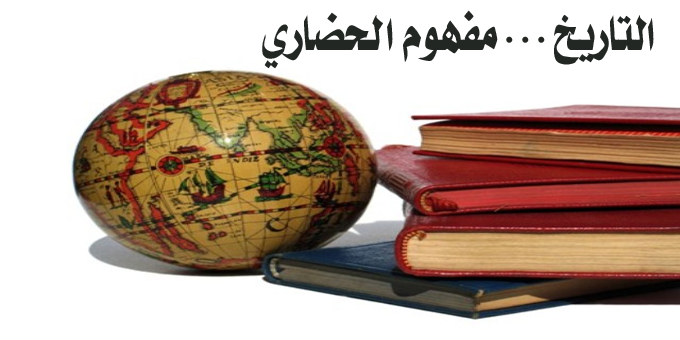
 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس