“ستيفان زفايج” هو الأديب النمساوي الذي يغني ذكره عن التعريف به، وتعد رواية “التباس الأحاسيس” هي واحدة من أعماله الأدبية الكثيرة التي خلّفها وراءه. أما الترجمة التي يبني عليها كاتب هذا المقال مراجعته للرواية فهي ترجمة “محمد بنعبود” المتقنة المنشورة عن المركز الثقافي العربي سنة 2017. هذا وقد ترجمت الرواية للعربية من قبل سنة 1988 بعنوان “فوضى المشاعر”، كما نشرت سنة 1993 مترجمة بعنوان “العواطف الحائرة“ .
التباس الأحاسيس والتمهيد
رولاند فتى تلقى تربية صارمة، وهو، بشكل قابل للتنبؤ، يبدأ حياته الجامعية في المدينة الكبيرة المفتوحة على كل الخيارات بانفلات خطير: خمر وعلاقات جنسية وإهمال تام للدراسة. هكذا تبدأ رواية “التباس الأحاسيس”. من هذا القليل المذكور يمكن توقع أشياء أهمها أن هذه المرحلة على وشك الانتهاء مفسحة المجال لما يهمنا حقًّا، ذلك أن ما تعبر عنه هذه المراحل عادة ليس تغييرًا جذريًا في الشخصية الرئيسية، وإنما مرحلة “تفريغ” يفترض أن يعود صاحبها لمساره الأصلي بعدها. هذا ما يحدث بالضبط. رولاند الكاره لكل ما يعبر عنه والده لا يعرف أن هذا المكروه هو ما يحتاج إليه بالتحديد: زيارة واحدة من الأب العابس والمحبط في ابنه؛ زيارة واحدة لم تكد تحتوي كلامًا فضلًا عن أن تحتوي توبيخًا، كانت كافية لإعادة الخط الأعوج لاستقامته.
لا بد من ذكر أن الرواية محكية على لسان شيخ ستيني هو رولاند الذي يستعيد ذكرياته. لماذا اختار “ستيفان زفايج” هذه التقنية لروايته “التباس الأحاسيس”؟ لأسباب أذكر منها: أولًا، حين كتب “زفايج” هذه الرواية لم يكن -مثل رولاند الشاب- في التاسعة عشرة من عمره، كان في السادسة والأربعين طبقًا لحساباتي غير الدقيقة، ما يعني أن كتابة الشاب من منظور عجوز يستعيد ذكرياته أسهل (وأصدق) من كتابة الشاب من منظوره الشخصي.
الأمر الثاني، أن إعادة النظر لهذه الحقبة الزمنية المنقضية (وقد صارت هكذا بسبب التقنية) ييسر ما يريده “زفايج” بالذات: نظرة أشمل على القصة؛ نظرة تتيح تأمل الحكاية من زوايا مختلفة، واستخراج الفوائد والعظات، ونحو ذلك مما كان ليبدو مفتعلًا سخيفًا لولا أنه وضع في قالبه الصحيح.
إن نرد مثالًا لهذا يقدمه لنا “زفايج” البارع من الصفحات الأولى، فمن خلال استعراض القصة -الذكرى- يستطيع رولاند العحوز التعبير عن والده بصورة أكثر تفهمًا وأقل عصبية، هي بالتأكيد أثر تقدمه في العمر واستيعابه للدنيا ولتربية الأبناء، بل إنه ليشير إلى نقاط محددة يعرف الآن، بعد مرور أعوام كافية، أنها كانت محورية مؤثرة، فيشكر والده على إحسانه التصرف فيها، كما في امتناعه عن محاربة تمرد ابنه كما يفعل الآباء عادة (مع اختلاف الأمثلة) بحماسة غير مفهومة، مكتفيًا بسؤاله ببساطة إن كان هذا ما يريد، وإن كان يعرف إلى أي نتائج يقود، معبرًا بصورة غير مباشرة عن أن الأمر، منذ هذه اللحظة، ليس شغله بل شغل ابنه الذي اكتسب مع تحرره نظيره من المسؤولية. لم تكن “التباس الأحاسيس” لتخرج على هذه الصورة لولا العثور على هذا المنظور.
أأنت ظمآن ؟
مثل معظم من في عمره، ومع بعض المبالغة في الاحتياج الناشئة جزئيًا عن طبعه وفي الغالب عن علاقته بأبيه (أو العكس، لا نعرف)، يسعى رولاند، بشكل مباشر ومن دون مواربة، لملء المكان الفارغ في خياله للبطل. هذه هي اللحظات المحفوظة التي يسعى فيها الإنسان الطبيعي لإيجاد هويته وتكوين شخصيته، وقد قرر رولاند -مع توضيح الأسباب- أن هذا اللجوء الكلي لأستاذه؛ هذا الانبهار الذليل الصافي نحو الرجل ذي الكاريزما العظيمة، هو هويته.
من إحدى وجهات النظر، الحياة كلها محاولة لفهم وتعديل علاقة المرء بوالديه، فليس ثمة غموض في استبدال هذا الرجل الجذاب والجاف والمدبر بأبيه صاحب النعوت نفسها. يمكن القطع أيضًا بأن ابتلاع رولاند لطباع أستاذه الثقيلة امتداد لابتلاعه لطباع أبيه، لكن ليس ثمة ما يؤكد هذا. المشكلة (أو المزية) في هذا الأستاذ أنه، مِثل كل رمز يبهر المقبلين على عالم الكبار، لم يمثل ذاته فحسب، بل مثّل عالمًا مفتوحًا على مصراعيه. كان المدخل لعالم الأدب ولحياة محترمة تنقذ رولاند من التيه. يقول رولاند :
“كنت كأنني تلقيت ضربة على قلبي، مفتونًا وقادرًا فقط على إدراك الأمور بطريقة مشغوفة، فتحفزت حواسي كلها بقوة. كنت أشعر للمرة الأولى أن أستاذًا، أن رجلًا يأخذ بلبّي. كنت تحت تأثير سمو قوة يغدو الانحناء أمامها واجبًا مطلقًا ولذة”.
من هذا الاقتباس وغيره يعاودني الشعور بأن “زفايج” أفضل من أن يُلخّص، وأن محاولة وصف كتاباته بعبارات مقالية باردة أقرب إلى تعدٍّ مهين. غوصه في النفس مُرضٍ إلى درجة أن الاكتفاء بقراءته يبدو كأنه فرض لازم.
المؤكد أن هذا الأستاذ لم يجذب رولاند وحده، وأن “ستيفان زفايج” منح هذه الشخصية، بأقل الكلمات، حياة تكفي لتخليدها. بلغته الشاعرية وعباراته المنتقاة، التي أحسنت إليها الترجمة، راح صاحب “التباس الأحاسيس” ينتفع من قدرته على كشف دقائق المواقف والإفصاح عما تحتمله من تفاصيل. النص -لو ابتغينا الاختصار- سلسلة من المواقف الموصوفة بأناة، حتى إن الرواية القصيرة تبدو -لشدة ما هي حقيقية وراسخة القواعد، ولطول جُملها ودسامتها- سرمدية منهكة.
اختزل أو لا تفعل، لا يهم
الترويج للمثلية الجنسية، باعتبارها ميلًا طبيعيًا وأسلوب حياة مقبولًا، يعارض منظومة قيمي الشخصية. يمكن الدوران حول النص لكنه سيظل يبدو، من كل زاوية، نقطة على مسار الدعاية الإعلامية المكثفة التي بلغت ذروتها في عصرنا الحالي. هل يمكن تفادي اختزال النص في شخصية الأستاذ الذي اتضح في النهاية أنه مثلي ويحمل ميلًا تجاه طالبه، باختزاله في شخصية رولاند التي -في رأيي الشخصي- تبدو أكثر إثارة للاهتمام وأولى بالاستئثار بالرسالة من الرواية؟ يمكن، لكن لم الاختزال أصلًا؟
كل هذه المقدمات تقود إلى نهاية الرواية التي لم تفاجئني وإن كانت زعزعت رغبتي في كتابة هذا المقال، لكن هذا لا يعني عجزها عن الاستقلال بنفسها والتأدية إلى نتائجها الصغيرة الخاصة. كل سطر في “التباس الأحاسيس” -وكل رواية قرأتها لـ”ستيفان زفايج”- عقدة بذاته؛ حبكة مستقلة بأهميتها وفوائدها. لا أنفي أن الزاوية الأخلاقية والدينية معتبرة في الحكم على النص، لكني أجادل في مدى اتساع سلطة هذه الزاوية، وما إذا كان من حقها الامتداد لشمول النص بكامله.
في دفاع “زفايج” عما يؤمن به، فإنه يدافع عن نقاط تفصيلية أوافقه بشأنها، كحق المرء -بغض النظر عن صفته- في الوجود، والقبول للجزء الإنساني غير القابل للزوال منه، وإنكار تنمر المجتمع على كل ما ومن لا يفهمهم. أتمنى لو يسعني القول إنه لا خلاف هنا مطلقًا وإنه من الممكن حمل النهاية على ما يُقبل، لكن الحقيقة أن هذه المراوغة الجبان قد مورست من قبل وهي لا تجدي.
هذا ما حماك
لأن كل طرف يجذبه بلا هوادة ومن دون اقتصاد، انتقل رولاند من التطرف في اللهو إلى التطرف في التعلق بالأستاذ والعلم وشكسبير ومشروع كتاب يجمعه وصاحبه. بيد أن النهاية لا تشير إلى أي خروج عن السيطرة، ربما لأن رولاند أفرغ كل غضبه من قبل في رحلاته الماجنة التي مثلت احتجاجه الشخصي على سلوك أستاذه معه، وربما لأنه أدرك من اليوم الأول (جزئيًا حتى) بشرية أستاذه؛ وهو أمر قد ازداد وضوحًا بدخول زوجته على الخط والاطلاع على ما يجري في حياته الخاصة، وربما لأن جُلّ غضب رولاند كان مصدره عدم الفهم، وفضوله الحبيس تجاه سر أستاذه؛ ما أدى أخيرًا لخيانته الرجلَ مع امرأته. الأخير هو الأكثر اتساقًا مع سياق رواية “التباس الأحاسيس”.
يقول رولاند :
“ولفرط ما لم أكن أرى فيه إلا مرشدًا لي، وبقدر ما كان شغفي غير متسامح ولا يرى في رفاقي إلا أعداء، كانت أرادةٌ غيور تُجدِّد كل يوم قسَمها بأن تتجاوزهم جميعًا وتهزمهم”.
كيف انتهى هذا الشغف غير الصحي؛ هذا التملك المريض، على نحو هادئ؟ ربما لأن رولاند حصل أخيرًا على التقدير والاحترام الذي كان يتمناه، بل وزيادة: حصل على تفسير جامع لكل ما أهمه على مدار شهور. خوطب بضمير المفرد الحميمي في الفرنسية بدل ضمير الجمع ونودي بالأخ. أشبعه هذا إلى درجة لا أظنها سمحت بالتفكير في حكم أخلاقي تجاه هذا التفسير. لم يحظ رولاند بنعمة التعرض لتأثير أستاذه فحسب، بل إنه تسنى له التأثير في الرجل أيضًا: أذكى حماسته بعد خمودها وأحيا فيه الكاتب بعد موته، وتحمل صلفه حتى أنهى كتابه حتى وإن لم يُنشر بعد ذلك.
محمود أيمن - اراجيك





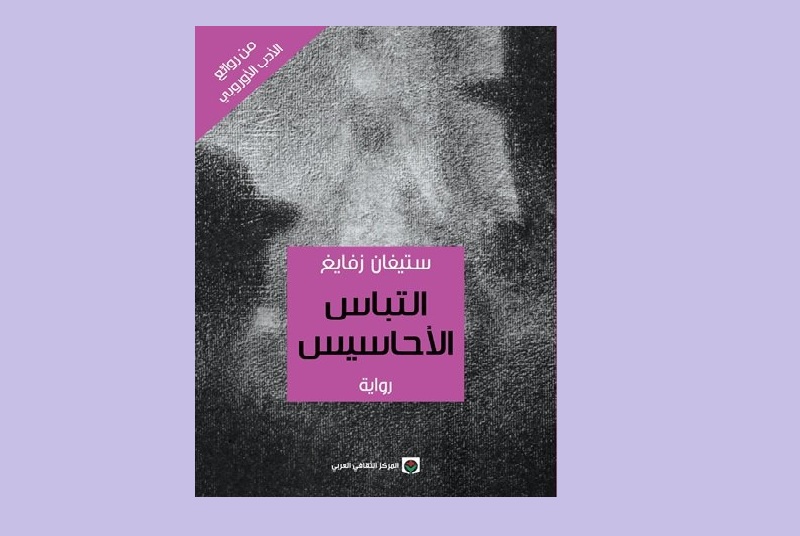

 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
